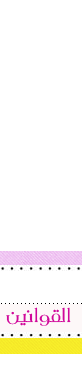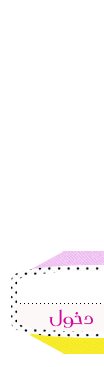بعد رمضان احذر هذه الخصال
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فإن الإسلام دين يدعو إلى مكارم الخصال، وينهى عن رذائلها، ولكي يسلم للمرء دينه يجب عليه أن يجمع بين الأمرين، وإذا كان الكثير منا قد جمع بين خصال الخير في رمضان من صلاة وصيام وزكاة وذكر لله عز وجل، وغير ذلك؛ فعليه أن يجتنب تلك الخصال المرذولة التي قد تذهب بتلك الثمرة الطيبة التي جناها المرء في هذا الشهر الكريم
وفيما يلي نعرض بعضًا من هذه الخصال التي أعلن الإسلام براءته منها
فساد المعتقد
نجد أن الكثير قديمًا وحديثًا قد اتخذوا آلهةً تُعبَد من دون الله، فقديمًا جعلوا الشمس والقمر والحيوان والأصنام آلهة يقدمون إليها القرابين، ويتوجهون إليها في كل شأن وحين، أما الآن فالهوى والعرف المزيف صارت آلهة تُعبد من دون الله، فتجد من هؤلاء من يقدسون الموتى ويدعونهم ويستغيثون بهم، ويقدسون الجاه والسلطان والمرأة والمال، حتى إنهم يبذُلون كل غالٍ في سبيلها، سواء أكان ذلك مخالفًا أم موافقًا للشرع والله تعالى يقول أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ الجاثية
البدع
البدعة هي كل ما لا أصل له في الدين، والمبتدع يأتي في الدين بأمر مخترع لا أصل له، يقصد بالسلوك عليه التقرب إلى الله تعالى، لكن النبي يخبر أن «ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته»، وطاعة الله تعالى لن تتم ولن تكون إلا فيما أمر، والانتهاء عما نهى، وليس فيما اخترعه العبد من بدع وفساد
والبدع تتدرج من الكبائر إلى الصغائر، فكل بدعة في دين الله، لا أصل لها استحسنها الناس بأهوائهم، ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها؛ حتى لا تؤدي إلى ما هو أشر منها، وقد قال «وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» أبو داود وصححه الألباني
مما جعل غير المسلمين يتهمون الإسلام بأنه دين البدع والخرافات والموالد، والتمسح بالأضرحة، وطلب الحوائج من الأموات والصالحين
ولذا فإن الإسلام يتبرأ من كل مبتدعٍ يوهم نفسه أنه يتقرب إلى الله تعالى بما ليس من أصل الدين في شيء، فهذه التمائم والرقى والعرافة والكهانة، وادعاء معرفة الغيب، والتوسل بالأموات، والاستغاثة بالمقبورين من الأمور المحدثة المردودة، كما قال «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» متفق عليه
مخالفة الباطن للظاهر النفاق
الأصل في الشخصية المعتدلة السوية أن يكون ظاهرها وباطنها سواءً، بل ينبغي أن يكون الباطن أكثر طهرًا وصفاءً من الظاهر؛ لأنه محل نظر الله تعالى، فإن «الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» مسلم ، إلا أن هناك صنفًا من الناس اهتموا بالظاهر وتركوا قلوبهم خاوية، وهذا عجبٌ وغرورٌ من النفس، فهي مع الناس شخصية مرجوة صالحة، وإذا اختلى بنفسه كان مبارزًا لله بالمعاصي ولا يبالي، فالمهم ثناء الناس عليه والتحدث عنه بأحسن وأفضل الصفات، فهو ينفق ويجود من أجل أن يُقال عنه جواد كريم، ويلبس زي أهل الصلاح من أجل أن يُشار إليه أنه من الصالحين، ويتحدث بألسنتهم من أجل أن يُقال إنسان محدّث وورع وفقيه، كما أنه دائم التقرب والتودد إلى كل ذي جاه وسلطان من أجل قضاء مصالحه، فهذه الشخصية تعمل ألف حساب للناس من أجل أن يتحدثوا عنها بكل أنواع المحامد، بل إنه يرجو أن يكون هو قِبْلة الناس التي تتوجه إليها؛ حتى يعلو اسمه ويكون صاحب شهرة، في حين أنه لو أعلن إخلاصه لله تعالى كان الله معه، بل كان سمعَه وبصره ويده التي يبطش بها ورِجْله التي يمشي بها، ومن كان الله معه؛ كان مقبولاً ومحبوبًا من أهل السماوات والأرض
وقد ذم رسول الله لباس الشهرة، فقال «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارًا» رواه ابن ماجه بإسناد حسن
فالثوب في أصله حلال، لكن إذا اشتهر الإنسان به، وعمد هو إلى ذلك؛ نال الوعيد المذكور، فنعوذ بالله من شهرة يمقتها الله عز وجل، ورسوله
الإقبال على الدنيا
يتبرأ الإسلام من تلك الأصناف التي استغرق كسب المال كل وقتها وجدها وفكرها، وصاروا مسخرين للمال ولعرض الدنيا الزائل، وإن كسب المال الحلال لا اعتراض عليه في حد ذاته، ولكن لا يكون هو أكبر الهم، ومبلغ العلم، فيحول بينهم وبين القيام بالواجبات الدعوية، وأداء حق الله من هذا المال
ومكمن الخطر في تسرب حب المال وعرَض الدنيا في استحواذهما على القلب حتى يكونا غاية لا وسيلة، بل يلهيان صاحبهما عن أداء الفرائض والنوافل، ويشتد طمعه في جمع المال إلى درجة لا يستطيع الفكاك منها إلى أن ينتزعه الموت
فالمؤمن الصادق يعرف أن القليل الذي يكفي خيرٌ من الكثير الذي يلهي، كما قال «قد أفلح من أسلم، ورُزق كفافًا، وقَنَّعه الله بما آتاه» مسلم
ولذا فإن المال والدنيا فتنتان يجران إلى المفسدة، وإنهما من أسباب هلاك الأمم، والحذر منهما واجب، كما قال تعالى قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً النساء ، وقال «ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها مَنْ قبلكم؛ فتهلككم كما أهلكتهم» متفق عليه
وكان النبي لا يعظّم الدنيا ولا يقيم لها وزنًا، فيقول عنها «ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» رواه الترمذي وصححه الألباني
فما بال المغرورون بها يشمّرون لها ويعكفون عليها، وكأنها دار البقاء وليست دار الفناء
قسوة القلب
وهناك صنف من الناس أصبحت قلوبهم قاسية كالحجارة بل أشد؛ وذلك لأنهم للمعاصي ملازمون، ولفعل السيئات مقترفون كبيرها وصغيرها، تلك التي تحرق القلوب، وتستوجب غضب الجبار، ومن غضب الله عليه؛ فقد خسر خسرانًا مبينًا، قال الله تعالى وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى طه
ولذلك فإن الإنسان قاسي القلب يكون بعيدًا كل البعد عن تلك التعاليم الربانية السمحة فهو دائمًا
لا يحب الخير للآخرين، بل يعمل جاهدًا على نزع هذا الخير من أيديهم، مهما كلفه ذلك من الجهد والتعب، والإسلام يمنع ذلك ويرفضه، فـ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» البخاري
يتمنى زوال النعمة عن الغير، فهو حاسد لغيره لا يتمنى له الخير، بل قد شارك إبليس في تمنيه زوال الخير عن الآخرين
عدم مكافأة أهل المعروف بالشكر؛ فهو دائمًا لا يسدي الشكر لأهله
سوء الظن بالآخرين
وذلك بسبب هذا المرض القلبي الذي جعله يظن بالآخرين السوء دائمًا، لا يعرف لأحد فضلاً أو خيرًا أو صلاحًا، فكل الناس عنده من أصحاب الشرور، فهو لا يثني على أحد، حتى أقاربه وأرحامه؛ لأن فِكْره وعقيدته جعلت الآخرين كأنهم يقفون له بالمرصاد، فكل الناس عنده بمثابة أعداء، وقد حارب الإسلام سوء الظن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ الحجرات بحسن الظن لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا النور ، وقال النبي «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» متفق عليه
وقد جعل الإسلام إحسان الظن من صفات المؤمنين الصادقين
عدم الاهتمام بأمر المسلمين
فهذا إنسان لا يهمه في الدنيا إلا نفسه ومصلحته وإن غرق الجميع، فالمهم أنه هو الذي ينجو وإن هلك الجميع، ولا يهتم بالآخرين في مشاكلهم والسؤال عليهم وصلتهم والتودد إليهم، بل لسان حاله يقول «أنا ومن بعدي الطوفان»، وقد حذَّر الإسلام من هذا عندما قال المعصوم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» الطبراني في الأوسط وضعفه الألباني
سوء الجوار
أوصى الإسلام بحسن الجوار ليعم الأمن والسلام، قال «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه
ولكن هناك بعض الناس لا يكفون أذاهم عن جيرانهم، سواء باليد أو اللسان أو السباب والشتائم وانتهاك الحرمات والسرقة، فعن الْمِقْدَاد بْن الأَسْوَدِ رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لأَصْحَابِهِ لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ قَالُوا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ» أحمد وصححه الألباني
عدم توقير الكبير والعطف على الصغير
المسلم الذي سرت روح الإيمان في دمه تراه إنساني المواقف، رحيمًا في المعاملة، رقيقًا في المعاشرة، يزن كل شيء بميزان الإسلام وإن لم يوافق تقاليده، يبتغي بعمله رضا الله تعالى، مخالفًا في ذلك هواه ونفسه، يفيض رحمة على الضعيف والمسكين والمنكوب وكل ذي حاجة من خلق الله، يُجِلّ الكبير ويعرف حقه عليه، والإسلام يتبرأ من الإنسان المخالف لهذا، فقد قال «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا» الترمذي وصححه الألباني
فاحرص أخي المسلم على صيانة دينك من هذه الخصائص المرذولة التي ذكرناها، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا، فتهدم ما بنيت من أفعال الخير في رمضان، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا؛ فهو نعم المولى ونعم النصير، وأن يقينا موجبات سخطه وعذابه، والحمد لله رب العالمين